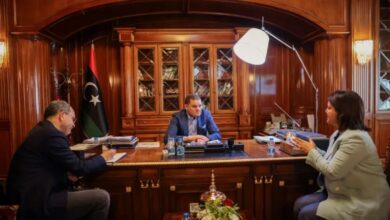منذ بداية القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين، اندلعت عشرات الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية، كان النصر حليفا لروسيا في أكثرها، وللدولة العثمانية في بعضها. وبالرغم من التحولات الجذرية التي شهدتها الدولتان في القرن العشرين، بانتهاء حكم القياصرة في روسيا بعد قيام الثورية البلشفية عام 1917 وقيام الاتحاد السوفييتي، وانتهاء الإمبراطورية العثمانية بعد قيام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة عام 1924 وإعلان قيام الجمهورية التركية، لم ينخفض حجم التوتر بين البلدين على مدار السنوات، خاصة بعد انضمام تركيا إلى حلف الناتو عام 1952، الأمر الذي لعب دورا مهما في سنوات الحرب الباردة ضد حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفييتي، وريث الإمبراطورية الروسية. إلا أن هذه التوترات لم تترجم إلى حروب أو صراعات كبرى كالتي كانت تدور بين البلدين في القرون السابقة، بالإضافة إلى أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد نموا في العلاقات الاقتصادية بينهما.
تنوعت القضايا الإقليمية والدولية التي شهدت خلافا كبيرا بين روسيا وتركيا، من جهة تعامل تركيا مع القضية الشيشانية، وفي المقابل تناول روسيا لقضية الأكراد. بالإضافة إلى قضية الملاحة في البحر الأسود، والنزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وتدخل حلف الناتو للحد من اعتداءات يوغوسلافيا (صربيا) على كل من البوسنة وإقليم كوسوفو، والنزاع التركي اليوناني حول جزيرة قبرص، ومرور الطاقة عبر بحر قزوين، والوجود العسكري السوفييتي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، والتي يعتبرها البلدان مناطق نفوذ استراتيجي لهما.
استمرت تلك الحالة حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات بعد تولي فلاديمير بوتين، رئاسة روسيا عام 2000، ووصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا عام 2002 بزعامة رجب طيب أردوغان، وهي المرحلة التي شهدت بداية التفاهم والتعاون الكبير بين البلدين، مع رسم أسس جديدة في السياسة الخارجية التركية وضعها أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الحالي، والتي سميت “صفر مشاكل” مع دول الجوار، واستمرت هذه المرحلة حتى الآن، خاصة السنوات العشر (2002: 2012) وهي التي يركز عليها المؤلف معمر فيصل خولي في هذا الكتاب.
يطلق الكتاب مصطلح “الشراكة” لوصف العلاقة بين روسيا وتركيا، فهي لم تتطور لتصبح تحالفا، لأن هذا يتطلب اتفاقا بينهما في كافة القضايا، وفي نفس الوقت لا يمكن وصف العلاقة بالتنافس، لأن هذا يعني أنهما يتنافسان في تحقيق هدف واحد. أما الشراكة فهي لا تعني التعاون على المستويات كافة، وإنما يمكن الاتفاق في مجالات معينة والاختلاف في قضايا أخرى بدون أن تتأثر العلاقة بينهما. كما يمكن الاتفاق على تحقيق هدف اقتصادي مشترك مثلا، من دون أن يؤثر ذلك على العلاقات السياسية.
على المستوى الاقتصادي، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية 2012 إلى 33 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات المتبادلة إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى إلغاء تأشيرات الدخول بينهما، وتخفيض الرسوم الجمركية. وبلغ عدد السياح الروس في تركيا 4 ملايين سائح، الأمر الذي جعل روسيا الشريك التجاري الأول لتركيا، فيما احتلت تركيا المرتبة السابعة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لروسيا.
يطرح الباحث سيناريوهين لمستقبل العلاقة بين روسيا وتركيا: يقول أحدهما إن الخلافات السياسية ستؤثر بشكل كبير على التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى، أما الآخر فمفاده أن التقارب الاقتصادي والتجاري بينهما سيساهم في المساعدة في تقريب وجهات النظر بشأن القضايا السياسية، وهو السيناريو الذي يرجحه المؤلف وأثبتته وقائع عديدة بالفعل. وتعد الأزمة السورية، والأوضاع في مصر، أبرز مثالين لذلك، فلم يتوقف كل من بوتين وأردوغان عن إبداء آراء معاكسة تماما للتعامل مع الأحداث في هذين البلدين، كما تتبع كل دولة سياسة مختلفة، حيث تدعم روسيا نظام الأسد سياسيا وعسكريا واقتصاديا، كما تحتفظ بعلاقات مميزة مع نظام السيسي، فيما تدعو تركيا دائما إلى ضرورة رحيل الأسد، وتساند حركات المعارضة السياسية والعسكرية ضده. ومع كل ذلك تبقى العلاقات الاقتصادية أقوى، فمن آخر ثمار التعاون بين البلدين توقيع اتفاقيات ضخمة تستهدف وصول حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار عام 2023، وحصول تركيا على تخفيض كبير لأسعار الغاز الروسي، وصل إلى 6%، اعتبارا من بداية 2015.
تم نشر هذا المقال بتاريخ
7/13/2015